
ينظر العسكر في مصر منذ أول يوم جاءوا فيه إلى السلطة، إلى المصريين على أنهم الجسر الذي يجب أن يعبروا عليه من أجل البقاء في الحكم ونهب ثروات البلاد، فلا مانع لديهم من أن يقتلوا مليون مواطن أو أكثر إذا كان هناك شعور بأن وجودهم يهدد حالة الاستجمام التي يعيشها العسكر في عروشهم، كما أنهم ينظرون إلى الدساتير والقوانين على أنها وضعت للفقراء فقط، لكي تنظم حالة الفوضى التي يعيش فيها المهمشون من الفقر والجوع، حتى تستقيم أمر “جبلاية القرود”، كما ينظر العسكر إلى الفقراء دائمًا.
وبالرغم من أن العسكر حينما يصارعون على السلطة ويخططون للانقلاب عليها يكون الباب دائما من خلال الدستور، كما حدث مع دستور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي وضعه عبد الرازق السنهوري، والتعديلات الدستورية التي وضعها المجلس العسكري بعد ثورة يناير ووضعها المستشار طارق البشري، ثم التعديلات الدستورية لعبد الفتاح السيسي والتي وضعتها لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، إلا أنهم وبمجرد الصعود على كرسي الحكم ينقلبون في أول إجراء لهم على هذا الدستور.
وضرب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، المثال مع سلفه جمال عبد الناصر في هذا السلوك، بشكل فج، خاصة وأنه تم بعد مقصلة سياسية للخصوم والمعارضين بشكل دموي، ورغم أن السيسي أقسم على أن الدستور لن يسمح لحاكم أن يجلس لأكثر من مدته، ولا مكان لذلك في مصر بعد الآن، خلال تصريحات المتعددة لوسائل الإعلام الأجنبية والمحلية، إلا أنه لم يختلف عن سلفه عبد الناصر في الحنث بوعوده، وضرب الدستور بعرض الحائط للجلوس في عرض البلاد مدى الحياة.

دستور عبد الناصر
يشير الكاتب الصحفي وائل قنديل إلى ما ورد في كتاب للباحث عمرو الشلقاني، بعنوان “ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية 1805- 2005″، يحكي فيه قصة التظاهرات التي جابت القاهرة هاتفة: يسقط الدستور.. تسقط الديمقراطية والحرية.. يعيش الجيش.. يعيش الزعيم، ثم وصلت إلى مبنى مجلس الدولة لمحاصرة رئيسه الرافض لتعديل الدستور الذي كان هو مهندسه، وحائكه القانوني، على مقاس النظام العسكري، وذلك خلال أول انقلاب لجمال عبد الناصر على الدستور الذي وضعه.
وتنجح الجموع في اقتحام بوابة المجلس المغلقة بالسلاسل الحديدية والجنازير، وتصبح على بعد خطواتٍ من رئيسه. وهنا يظهر العسكري الثائر طالبًا من رئيس المجلس الخروج للجماهير الغاضبة لامتصاص غضبها، وما أن يخرج، حتى يتحول إلى فريسةٍ سهلة، ويتلقى الركلات والصفعات والشتائم، بوصفه “الخائن الجاهل”، فيظهر ضابط الجيش منقذًا لحياته، فيخرج ملفوفًا في سجادة إلى بيته.
كان رئيس مجلس الدولة وقتها الذي وضع الدستور وتم تلقينه درسا قاسيا لمجرد رفضه التعديلات الدستورية من نظام عبد الناصر هو المستشار عبد الرازق السنهوري، الذي امتدت يده لحياكة دستور 1932 ليكون على هوى ضباط يوليو 1952. وأما الضابط الثائر الذي خلصه من بين براثن غضب المواطنين الشرفاء فكان عضو مجلس قيادة الثورة الصاغ صلاح سالم. وأما التظاهرات فقد أدرك السنهوري لاحقًا أن من أعد لها وأخرجها ووجهها إلى مقر مجلس الدولة لتأديب رئيسه على انحيازه للديمقراطية في أزمة مارس 1954 هي هيئة التحرير (التي يقابلها “ائتلاف دعم مصر حاليًا”، بأوامر من البوليس الحربي “المخابرات الحربية حاليًا”).
“إيه يعني لما نعدم مليون مصري في سبيل نجاح المسيرة؟”، عبارة صاح بها الرائد صلاح سالم، العضو البارز في الفصيل الموالي لجمال عبد الناصر داخل مجلس قيادة الثورة في فبراير 1953. ليرد عليه العقيد يوسف صديق قائلا: “أنا معملتش ثورة عشان أعدم المصريين وأنكل بيهم”، والعقيد يوسف صديق هو الضابط اليساري الذي استقال من مجلس قيادة الثورة قبل شهر من هذا النقاش الحاد.
و”صديق” هو مُنقِذ انقلاب 1952، فقد تحرك قبل ساعة الصفر للسيطرة على قيادة أركان القوات المسلحة المصرية، عقب كشف خطة الانقلاب، فأجهض بذلك التحرك المضاد للقيادات العسكرية الموالية للملك فاروق الأول. وما لم يكن في حسبان العقيد صديق هو ما سيتعرض له من زملاء الانقلاب بعد عدة أشهر من نجاحهم. فهم لم يزجوا به في السجن فحسب، وإنما اعتقلوا واعتدوا على زوجته وزوج ابنته وآخرين من أفراد عائلته، والسبب هو رفضه لحكم العسكر، ودعمه لنظام برلماني ديمقراطي.

دموية دساتير العسكر
زادت امتيازات الجيش في الدساتير المصرية بشكل مطرد منذ انقلاب عام 1952. ففي دستور عام 1923، كانت جميع القوانين التي تحكم الجيش وقوات الشرطة بالكامل في أيدي المشرّعين في البرلمان المنتخب، ما عكس ركنًا أساسيًا من أركان السيطرة المدنية المنتخبة على المؤسسات المسلحة. لكن حينها لم يكن الجيش وقوات الشرطة المؤسسات المهيمنة، إذ كانت كفة ميزان القوى تميل إلى حدّ كبير لصالح القوات المسلحة البريطانية في مصر.
ثمّ أتى انقلاب 1952 وغيّر هذه الظروف بشكل كبير، فهو لم يكن انقلابا ضد النظام الملكي فحسب، بل أيضا ضد برلمانٍ منتخب. فبعد مغادرة فاروق الأول، أرادت أقلية في صفوف الضباط الحاكمين دعوة البرلمان للانعقاد واستئناف الحياة السياسة الديمقراطية الدستورية. من بين أولئك الضباط العقيد يوسف صديق، وأحمد شوقي، ورشاد مهنا، والرائد خالد محيي الدين، وغيرهم. بيد أنّ الأغلبية الساحقة في مجلس قيادة الثورة كانت ترغب بديكتاتورية عسكرية. ونظرا لكون الأقلية المؤيدة للديمقراطية مسيطرة على قوة عسكرية مهمّة، وخاصة سلاح المدفعية، كان لا بد من التوصل إلى حل وسط، وهو “فلنطلب رأي القضاة”.
يقول الباحث عمر عاشور، في مقال له: إنه في 31 يوليو 1952، صوّت مجلس الدولة – الذي كان مسيسًا للغاية– بنسبة 9 أصوات إلى صوت واحد ضد انعقاد البرلمان المنتخب. كان القاضيان عبد الرازق السنهوري، رئيس المجلس، وسليمان حافظ، وكيل المجلس، ضدّ حزب الوفد الذي كان الحزب الأكثر شعبية في ذلك الوقت. وأراد القاضيان إقصاء الحزب ومنعه من السيطرة على البرلمان. وفي مرحلة لاحقة، أفتيا بدستورية رئاسة العسكر للحكومة المدنية، فصار اللواء محمد نجيب رئيسا للوزراء. قضى تسعة قضاة غير منتخبين بإسقاط خصومهم السياسيين المنتخبين. وبذلك لم يسقطوا ما بقى من ديمقراطية مصر الهشة فحسب، وإنما قَنّنّوا حكم مَنْ استولى على السلطة بالسلاح.
إلا أنّ مسودة دستور عام 1954 حاولت العودة عن مسار مجلس قيادة الثورة فيما يتعلّق بحكم العسكر. فلم تقم المسودة بحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تحت أي ظرف من الظروف فحسب (مادة 20)، بل فرضت أيضا على الدولة تثقيف المجندين وتعليمهم (مادة 180). وبموجب المسودة تمّ إنشاء مجلس الدفاع الوطني، ولكنها حسرت دوره ليكون استشاريا فقط بشأن ثلاث قضايا محددة وهي: إعلان الحرب، المصالحة، التدابير الدفاعية (مادة 185). وتُركت معظم القوانين التي تنظّم المؤسسات المسلحة (الجيش وقوات الشرطة) بيد البرلمان المنتخب، والذي أعطته المادة الأولى من مسودة الدستور مكانة خاصة: “مصر هي جمهورية نيابية برلمانية”.
لم يتم التصديق بالطبع على مسودة الدستور، فعبد الناصر وفصيله العسكري لم يريدا دولة ذات مؤسسات ديمقراطية فاعلة، وإنما ديكتاتورية عسكرية مبنية على تمجيد الزعيم الملهم. وبدلا من التصديق عليها، عثر المؤرخ صلاح عيسى على النسخة الوحيدة من دستور 1954 في العام 1999، في الطابق السفلي لمركز أبحاث تابع لجامعة الدول العربية. فكتب بعد ذلك كتابا بعنوان “دستور في سلة مهملات” ليعكس القصة الحزينة للديمقراطية الدستورية في مصر.
واختتم عبد الناصر دستور 1954 باعتقال سليمان حافظ، وكيل مجلس الدولة، في 1956 حين اختلف مع عبد الناصر، بعد أن قام “بتقنين” قيام جمهورية العسكر على أنقاض نظام برلماني. وبعد أن تمّ الإفراج عنه، كان لديه ما يقوله لصديقه وحيد رأفت، القاضي الوحيد الذي صَوَّتَ لإعادة البرلمان وتقويض الحكم العسكري في يوليو 1952: “ندمت على دعم حركة الجيش ضد الحكم البرلماني الديمقراطي. أظنّ أنّ سجني ومعاناتي هما عقاب لي على هذا الذنب”.

المنهج ثابت
يقول الكاتب الصحفي وائل قنديل: إنه من 1954 إلى 2019، هناك فاصل زمني يمتد إلى 66 عامًا تبدلت فيها أمورٌ وتغيرت أحوال، إلا أن المنهج بقي ثابتًا، وإذا كان الهتاف بسقوط الدستور وموت الديمقراطية والحرية قد تردّد على ألسنة “المواطنين الشرفاء” المسيرين قديمًا، فإن مضمون الهتاف ذاته يتكرّر في 2019. ولكن على ألسنة أساتذة علوم سياسية، تخرجوا في أمريكا التي توصف بواحة الديمقراطية، من نوعية المعتز بالله عبد الفتاح، الذي يقول إلى الجحيم بالديمقراطية إذا كانت ستعطل مسيرة الزعيم الملهم ورؤيته التنموية النهضوية التي تلتهم الأخضر واليابس من الحريات وحقوق الإنسان والحياة السياسية في مصر.
وأضاف قنديل أن مضمون الهتاف نفسه سمع أيضًا تحت قبة برلمان عبد الفتاح السيسي، حين طالب نواب بعدم الاكتفاء بتعديلات الدستور، وإنما نسف الدستور كله، وصياغة دستور جديد، يناسب ذوق الزعيم، الذي هو أبو الدستور وأبو القانون وأبو الوطن نفسه.
على أن ثمّة فروقًا واضحة بين مصر 1954 ومصر 2019، إذ كانت هناك، لا تزال، أصوات من النخبة القانونية والقضائية تستطيع أن تجهر بالاعتراض وتدفع الثمن، حتى وإن كان الثمن اعتداءاتٍ جسدية، قيل إنها بلغت ضرب رئيس مجلس الدولة بالحذاء. أما الآن فالكل مختبئٌ في جلده، لا يقوى على الاعتراض، أو حتى إبداء الرأي في مواد تشنق استقلال الهيئات القضائية وتتخذها سبايا في قصر الزعيم، إلى الحد الذي انزعج فيه مجلس القضاء الأعلى من خبرٍ سرعان ما تم حذفه عن اعتراضاتٍ قضائية على تلك المواد، ليصدر تكذيبٌ مكتوبٌ بحبر الرعب والرجفة، لمثل هذه الأخبار المضللة.
يضاف إلى ذلك أن النخبة السياسية في ذلك الوقت لم تكن من البؤس الذي يجعلها تقع في ارتباكٍ عميقٍ بين التناقضات الجذرية، والخلافات العابرة مع السلطة، فلم يتضح في الوضع الراهن ما إذا كان الخلاف مع سلطة الانقلاب يتعلق بأنها انقلاب على كل شيء، أم ينحصر في خلافٍ على ممارساتها، بحيث إذا توقفت عن هذه الممارسات والانتهاكات تصبح جيدةً وشرعيةً ومحترمة.
وفيما يتعلق بالمتاهة الدستورية العبثية، تساءل قنديل: هل المسألة تتعلق بموقف مبدئي قطعي، يرفض منطق العبث بالدستور، كلما أرادت السلطة، أم هو خلافٌ على مواد وموافقة على أخرى في “بازار” التعديلات؟.
وأكد أن السيسي لم يخرج في اللعبة الدستورية فائزًا بتمرير التعديلات فقط، وإنما مكسبه الأكبر أنه استدرج المعسكر الرافض للانقلاب، من حيث المبدأ، إلى مجرّد معارضةٍ لبعض السياسات والإجراءات فقط، تلعب في المساحة المخصصة للمتمسكين بمشروع 30 يونيو 2013، لكنهم متضرّرون من شراسة السلطة ضدهم، وتسقط، أو تتجاهل جذور المأساة، وتتغافل عن أن هناك نظامًا شرعيًا يواجه تعذيبًا وتنكيلا، تحت الأرض التي يلعبون فوقها.
وتساءل قنديل: “هل المعركة مع السيسي هي تناقض جوهري مع نظام دموي يحرق الجغرافيا السياسية والاجتماعية والحضارية لمصر، تنبغي إزاحته، أم خلافٌ مع سياساتٍ وإجراءاتٍ، بزوالها يكتسب جدارة أخلاقية ودستورية؟”.
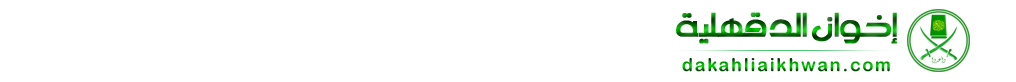 إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية



