
نطقت بهذه العبارة وأنا أمر على إحدى لجان «الاستفتاء» في آخر ساعات التصويت؛ لما وجدت شبابًا وفتيات وربات بيوت يرقصون بشكل هستيري على أنغام موسيقى صاخبة، وقد تعالت أصواتهم بالغناء تأييدًا لتلك المهزلة. قلت: مساكين، أعلم أن كل واحد منهم قد تقاضى «يومية» نظير هذا العمل الحرام لا تتعدى –غالبًا- مائتى جنيه، وهو مبلغ لم يعد كبيرًا بالنسبة لهؤلاء المستأجرين، ولكنها الحاجة التى اضطرتهم لهذا التفريط، بالإضافة إلى غياب الدين والضمير لدى «المقاول» الذي أتى بهم إلى هنا.
وهذا المشهد يلخص حال البلد، الذي كان يمكن أن يكون في مصاف الدول العظمى، لولا هذا الوباء الذي ابتلينا به «حكم العسكر»، وما جروه علينا من خراب حتى عدنا نردد ما قيل قبلنا عن حال المحروسة عندما تصيبها الجوائح: “وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا”.
ولو أن هذه «التمثيليات» تفيد في شيء ما اعترضنا عليها، لكنها -فى الواقع- نصب واحتيال. وإذا كان هذا الدجل يصلح للاستخفاف بأجيال خلت فلم يعد يصلح الآن فى عصر صار فيه العالم قرية صغيرة، وفى زمن صار المواطن هو الصحفى والإعلامى؛ فلا مجال إذًا لتشويش أو خداع أو حجب، فالمستبد القديم الذى كانوا يحسّنون صورته، ويزورون لصالحه ويشوهون معارضته ورغم ذلك كان يبدو بطلًا مغوارًا و«كاريزما» لا نظير له، انكشفت الآن حقيقته مهما بدلوا وغيروا، ومهما زوروا وتحايلوا؛ ذلك أن الرقيب صار فى كل مكان لا يعجزه شىء ولا تخفى عليه خافية.
إنهم يسلكون مسالك الغشوم الذين كان يحكم المصريين فى الخمسينيات والستينيات، بالتصرفات نفسها والاستخفاف ذاته، ما جعلهم مادة عظيمة للسخرية؛ إذ منذ بدأت التمثيلية والشباب يتداولون «فيديوهات» يصح أن نطلق عليها «خوارق الاستفتاء»؛ مثل الكفيف الذى استرد بصره بمجرد دخوله اللجنة، وقد أقسم للقاضى على ذلك؛ والمسنة التى بلغت من العمر (105 سنوات) وأتت حبوًا للإدلاء بصوتها، ما أخرجها إلا (حب مصر!!)؛ والمريض الذى عز عليه أن يبقى فى سريره لا يدلى بصوته، فاتصل بالنجدة التى أتته فى الحال فأنقذته من حالة الاكتئاب حيث حمله الجنود إلى لجنته وأعادوه سعيدًا بعد التصويت؛ ومثل العروس التى أقسمت بألا تذهب إلى بيت الزوجية حتى تقول نعم، وبالفعل لبى العريس رغبتها وذهبا سويًّا إلى لجنتهما يحوطهما المهنئون من كل مكان على هذا العمل الوطنى العظيم.
والقائمة تطول لعل آخرها تلك الفتاة التى خرجت من حجرة العمليات إلى لجنة الاستفتاء رأسًا لتستكمل الإفاقة هناك، غير مئات النساء اللاتى وجدن أنفسهن يرقصن أمام اللجان بمهارة تعجّب لها الناس؛ تعبيرًا أيضًا عن حبهم لمصر!!
من أين كل هذه الأموال التي أنفقت؟ ومن يحاسب من؟ وما مصلحة المنفق إذا لم تكن من أموال الدولة ودافعى الضرائب؟ أم أن من دفعوا فعلوا ذلك رغمًا عنهم؟ فى كل الأحوال هناك جريمة كبيرة فى حق البلد -إن جاز أن نسميه بلدًا- وهناك استغلال لحاجة الناس وعوزهم، وهناك تغرير بالشباب والفتيات، واستدراج لهم إلى مواطن الفساد، وهناك شياطين إنس منتفعون هم حلقة الوصل بين المجرمين الكبار وهؤلاء الضحايا الذين لا حول لهم ولا قوة.
ولا تسل بعد ذلك: لم تخلفنا فى التعليم، وفي الاقتصاد وفى الأمن إلخ؛ لأن الأكاذيب لا تقيم دولاً، إنما يقيمها الصدق والعدل، أما هذ المساخر فلا أثر لها سوى المزيد من الفساد والفقر. ولو أنهم حريصون على صالح البلد لتركوا الأمور تسير حسب رغبة الشعب ومناه، لكنهم يريدونها لأنفسهم، كأنها (عزبة) ورثوها كابرًا عن كابر. ويؤكد المتابعون لو أن استفتاء تم دون هذا المهرجان ما ذهب أحد إلى لجنة، بدليل –وهذا من مصادر موثوقة- أن 7.4% ممن لهم حق الانتخاب هم من صوتوا بـ«نعم» وقد أُخرجوا بالطرق التى علمناها، وبعدما تم تسخير أجهرة الدولة كافة لهذا الغرض.
هل ما جرى يستدعى أن نقول «مفيش فايدة»؟ العكس هو الصحيح تمامًا؛ فإنه فى مثل هذه الأزمنة التى يكثر فيها الفساد والهرج يكون الجو مهيأ للدعوة؛ إذ لا تزال الفِطر السليمة أكثر من التى فسدت. ونؤكد أن هناك وعيًا وفهمًا أكثر من أى وقت مضى، والفضل لله ثم لوسائل التواصل الحديثة. وستشهد الأيام المقبلة مواجهات وصراعات سافرة بين أهل الحق وأهل الباطل، سرعان ما ستُحسم -إن شاء الله- لصالح الحق وأهله؛ ذلك أن الباطل طغى وعم فساده، وهى اللحظة الفاصلة التى تُحتز فيها رأسه، ذلك وعد الله، ولن يخلف الله وعده.
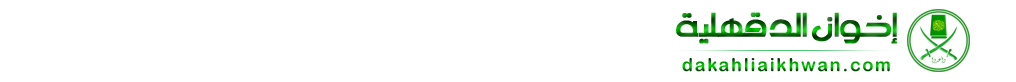 إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية



